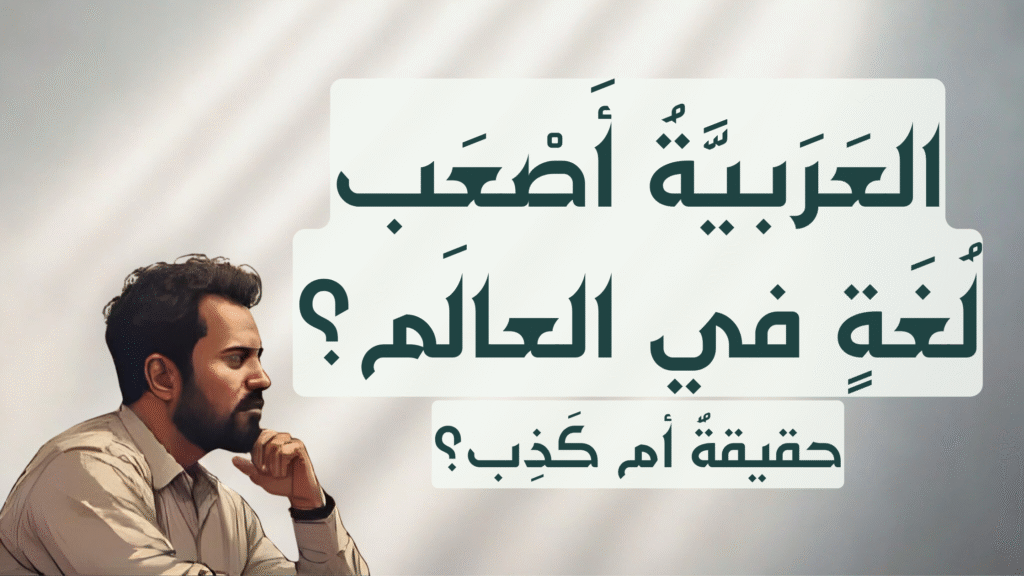﴿أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ﴾
في أثناءِ مَعْرِضِ القاهرةِ الدَّوْلِيِّ للكتاب، فوجِئْتُ بِمَنْ يبحث عن كُتُبٍ كُتِبَتْ باللَّهجة العامِّيَّة في موضوعات إسلاميَّة كالسّيرة النَّبويَّة وقصص الأنبياء، ودفعني هذا أنْ أبحث عن مِثل هذا المحتوى، بعد أنْ قرأتُ تعليقات بعض القرّاءِ بأنَّهم أحبّوا هذه الكُتُبَ، ووصفوها بالسُّهولة، وقالوا إنَّهم أغلقوا كُتُبًا أُخرى بعد أنْ قرؤوا سَطْرَيْنِ بالعربيَّة الفُصْحى فوجدوها عسيرةً مُمِلَّة، ثمَّ شاركتْني زوجي مَنْشورًا على وسائل التَّواصلِ لِكاتبةٍ مِصْرِيَّةٍ مُنْزَعِجَةٍ مِن دعوةِ كاتبٍ إلى الكتابة بالفُصحى، ومِنْ زعمه أنَّ عدمَ إتقان الفصحى دليلُ جَهلٍ وعجزٍ، وكيف لِمثل هذا الكاتِبِ أنْ يكونَ مُثَقَّفًا وهو يرفض الكتابة بالعامِّيَّة؟! أليست العامِّيَّةُ لغةَ أدبٍ كالعربيَّة الفُصحى؟! وقال مُحِبّونَ للعربيَّة إنَّنا وصلنا إلى الحضيض اللُّغويِّ، وما عاد مُمْكِنًا لمعلِّمٍ أنْ يُؤثِّر إيجابًا بتعليم العربيَّة مِنْ دونِ أنْ تحمل هذه الرسالةَ دولةٌ، وتدعمها بالقرارات والقوانين والإجراءات المُلْزِمَة، فكان السؤالُ: ما نَمْلِكُ أنْ نفعل إذًا؟
ما الفُصْحى؟ ومَا العَامِّيَّة؟
لا جِدالَ يوجدُ صراعٌ بينَ الفصحى والعامِّيَّة، لكنَّ سؤالًا مُهِمًّا يغفُل عنه كثيرون مِمَّنْ يتحدَّثون في هذا الموضوع، ما اللُّغة الفصحى؟ وما العامِّيَّة؟ وهل العامِّيَّة ظاهرة عربيَّةٌ فقط؟
العربيَّة الفصحى هي لغة القرآن الكريم، ولغة النبيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ، وهي لُغة العلم والأدب والإنتاج الفكريِّ عامَّةً، والعامِّيَّة هي لغةُ الحياة اليوميَّة في المنزل والشّارع والسّوق،
«فالفصحى لغة الفكر، والعامِّيَّة لغة الحياة الاجتماعيَّة، ولكلِّ منهما مفهوم النصِّ ومفهوم الخطاب» [تمام حسّان – مفاهيم ومواقف في اللغة والقرآن ٣٤]
كلاهما يُعَدُّ لغةً من حيثُ تعريفُ اللُّغةِ أنَّها نظام مِن الرُّموز الصَّوْتِيَّة. والمواقف التي يتعرَّض لها الفردُ هي التي تُحدِّد المستوى اللُّغويَّ الذي يستخدمه، فخطيب الجُمُعَة مثلًا يستعمل العامِّيَّة في حديثه مَع البقَّال والجزَّار، ويستعمل الفُصْحى إذا اعتلى المِنْبَرَ، وكَذا الصَّحَفِيُّ يُكَلِّمُ زوجَهُ بالعامِّيَّة، ويكتب الأخبار ويُحرِّرها بالفصحى.
«ولكنَّ أبناء الجماعة اللُّغويَّة يقفونَ مِن الفُصحى موقفًا غيرَ موقفهم مِن العامِّيَّة. فالفصحى تُحترم اجتماعيًّا وتُحترم قواعدها عند المُثَقَّفينَ، كما تَدعم النماذجُ الأدبيَّةُ والكُتُبُ الثَّقافيَّة والعلميَّة مكانةَ الفصحى. ويُؤدّي هذا في حالاتٍ كثيرةٍ إلى أنْ جعل استخدامَها موحَّدًا -أو يكاد يكون موحَّدًا- عند كلِّ أبنائها، حتّى وإنْ كانوا مُنْفَصِلينَ جُغرافيًّا واجتماعيًّا عن بعضهم البعض… ولكنَّ العامِّيَّة تُعَدُّ في رأي مُستخدميها غَيْرَ مُقَنَّنَةٍ مِن النّاحِيَةِ النَّحويَّة… ولا يقف أبناء الجماعة اللُّغويَّة مِن العامِّيَّة موقف الاحترام، ولذا لا تُستخدَمُ العامِّيَّةُ في الكتابة الرَّسميَّة ولا في المجالات الثَّقافيَّة والعِلميَّة تاركةً ذلك للُّغة الفصحى» [محمود فهمي حجازي – علم اللغة العربية ١٨]
والعامِّيَّة ظاهرةٌ طبيعيَّة في كُلِّ اللُّغات، تنشأ
«متى انتشرت اللُّغةُ في مناطقَ واسعةٍ مِن الأرض… وتكلَّم بها جماعات كثيرة العدد، وطوائفُ مختلِفةٌ مِن النّاس، استحال عليها الاحتفاظ بوَحْدَتِها الأولى أَمَدًا طويلًا، فلا تَلْبَثُ أنْ تَنْشَعِبَ إلى لَهَجاتٍ، وتسلك كُلُّ لهجة مِن هذه اللَّهَجاتِ في سبيل تَطَوُّرِها مَنْهَجًا يختلف عن منهج غيرها، ولا تنفكُّ مسافةُ الخُلْفِ تتَّسع بينها وبين أخواتها حتّى تصبح لغةً مُتَمَيِّزة مُسْتَقِلَّة» [علي عبد الواحد وافي – علم اللغة ١٧٢]
بَيْدَ أنَّ العربيَّ القَصيرَ النَّظرِ يَظنُّ جهلًا أنَّ العامِّيَّة ظاهرةٌ في لُغته فقط؛ لأنَّه ما درَس اللُّغاتِ الأخرى ولا اطَّلع على أبحاثِ الآخرينَ فيما عنَّ لِلُغاتهم مِن ظواهر، ومِن المَنْطِقِيِّ ألّا تنفردَ العربيَّة بظاهرة العامِّيَّة، فالعربيةُ لُغَةٌ مِن اللُّغات، ما يعتريها مِن ظواهرَ يعتري غيرَها أيضًا.
والعامِّيَّة تختلف عن الفصحى في أصواتها وتركيباتها وأساليبها،
«وَمِثْلُ هذا حدث بين البُرْتُغالِيَّة في البرتغال والبُرْتُغالِيَّة في البرازيل، فقد وصل الخِلاف بينهما إلى القواعد نفسِها… وهذا هو ما يحدث الآنَ للإنجليزيَّة والألمانيَّة، فقد أخذت إنجليزيَّةُ الولايات المُتَّحدة بأمريكا تختلف عن إنجليزيَّةِ الجُزُرِ البريطانيَّة في كثير مِن المفردات وأساليب النُّطق، وأخذت ألمانيَّةُ سويسرا تبتعد عن أصلها، ويزداد تأثُّرها بجارتها الفرنسيَّة حتّى توشك أنْ تكونَ لهجة مُتَمَيِّزَة عن ألمانيَّةِ الألمان» [علي عبد الواحد وافي – علم اللغة ١٧٤]
إنَّ العَامِّيَّةَ ظاهرةٌ مُتوَقَّعةٌ في كُلِّ لُغَةٍ
«مهما ضاقت الرُّقعة الجغرافيَّة لاستعمالها، وهي معرَّضَة لتعدُّد لهجاتها باختلاف صُوَرِ مفرداتها وتراكيبها وطرق استعمالها بحسب التَّداوُليّات والمواقف الدّاعية إلى هذا الاستعمال، ثمَّ بحسب طوائف المجتمع وشواغل طوائفه، إذْ تتَّخذ كلُّ طائفةٍ نظامًا صوتيًّا خاصًّا بلهجتها، وآخرَ مُعْجَمِيًّا يُسمّي وسائلَ عَيْشِها، ثمَّ نظامًا تركيبيًّا تمتاز به تراكيب جُمَلِها عن غيرها مِن لَهَجات الطَّوائف الأخرى.» [تمام حسّان – مفاهيم ومواقف في اللغة والقرآن ٣٢ بتصرُّف يسير]
ومِن الكُتب التي درست العامِّيَّة الفَرَنْسِيَّةَ ومدى اختلافِها عن الفرنسيَّة الفُصحى كتاب «هنري بوش» «le langage populaire»، وذكر د. تمّام حسّان كذلك نموذجًا لعامِّيَّةِ «الكوكني Cockney» التي يسعملها أهلُ لندنَ
«وتقف صامدةً أمامَ اللُّغة الإنجليزيَّة القوميَّة دون أنْ يعترض أحدٌ على استعمالها، بل إنَّ أستاذنا الشَّهير “فيرث” كان يَسوقُ بعض الشَّواهد مِن تلك اللَّهجة، وما زِلْتُ أذكر بعضها، فكان واحدٌ منها يقول:
Aien gen a geء wan fo beء
I am going to get one for bert
وهو يعني: أنا ذاهب لأُحْضِرَ كأسًا مِنْ أجلِ “برتراند”، وكان القائل بين أصحابه في المشارب، فالأستاذ الإنجليزيُّ لم يجدْ مانعًا مِن استعمال شواهدَ مِن العامِّيَّة تشير إلى ظاهرة لُغويَّة معيَّنة، مثل الوقوع في اللحن مِن وجهة نظر اللُّغة القوميَّة بشواهدَ مِن العامِّيَّة تتميَّز بورودِ الهمزة -وهي ليست مِن أصوات اللغة الإنجليزيَّة- في موقع لا تسمح هذه اللغة القوميَّة بوقوعها فيه، على غِرار ما يحدثُ في نطق الأصوات العامِّيَّة الدّالَّة على (القاف والجيم والظاء مثلًا) على ألسنة المُتكلِّمين بالُّلغة العربيَّة الفصحى» [تمام حسّان – مفاهيم ومواقف في اللغة والقرآن ٣٢ – ٣٣]
أليست العامِّيَّة إذًا ظاهرةً طببيعيَّةً في كُلِّ اللُّغات؟ فَلِمَ كان صراعٌ بين العربيَّة الفصحى والعامِّيَّة؟
صِراعٌ بين الفُصْحى والعامِّيَّةِ
مع اتِّساع رقعة دولة الإسلام، وانتشار اللِّسان العربيِّ في مُخْتَلِفِ البلدان، وتأثُّرِ ألسنة شتّى الأقوام به، وتأثُّرِه بألسنتهم أيضًا، نشأتِ العامِّيَّة وعاشت إلى جانب الفصحى دون صراع، وظهر بين الخواصِّ والعوامِّ اللَّحنُ، أي الغلط اللُّغويُّ، فانبرى علماء العربيَّة يؤلِّفونَ المُؤَلَّفات التي تُصحِّح أشيع الأغلاط اللُّغويَّة، منها: «ما تَلْحَنُ به العوامُّ» للكسائيِّ (ت: 189هـ)، و«ما تلحن فيه العامَّة» لثعلب (ت: 291هـ)، و«لحن الخاصَّة» لأبي الهلال العسكري (ت: 395هـ)، واستمرَّتْ حركةُ التَّصْحيحِ هذه حتّى عصرِنا الحاضر، وقد استهدفت هذه المُؤَلَّفات تقويم الألسنة وتصحيح الأخطاء والأغلاط، لا دراسةَ العامِّيَّة بوصفها لغةً مُستقلَّة كما درسها المُسْتَشْرِقون المُحْدَثونَ.
وبَقِيَتْ العامِّيَّة لغة الحديث اليوميِّ لا تزاحم الفصحى إلى النِّصف الثّاني مِن القرن التّاسعَ عَشَرَ، حيثُ تأخَّر أبناء العربيَّة، وضَعُفَ لسانهم، فبرزت الدَّعوة إلى استبدال العامِّيَّة بالفصحى لغةَ أدبٍ وكتابة حلًّا لهذا الضَّعْف، وهَدَفَتْ هذه الدَّعوةُ الخبيثةُ إلى أن تُنحِّيَ العامِّيَّةُ الفصحى وتصيرَ لغةَ الحديث في كُلِّ مَحْفِل ومَوقف، ولغةَ الكتابة والأدب، ولْتَكُنِ الفصحى لغةَ القرآن الكريم والعبادة والأدب القديم فقط، فمَنْ أوَّل مَن تَبَنّى هذه الدَّعوة؟
إنَّ تعرُّفنا إلى أصحاب هذه الدَّعوة يكشف لنا نواياهم ودوافعهم، تجيبنا عن السَّؤال الأستاذة بكلية الآداب بجامعة الإسكندريَّة د. نفّوسة زكريّا سعيد –رحمها الله- في كتابها الرائع: «تاريخ الدَّعوة إلى العامِّيَّة وآثارها في مصر»، وهو كتاب رائع لأنه ناقش هذه المسألة نقاشًا علميًا مؤرَّخًا موثَّقًا مُحايِدًا، وليس عجيبًا أنْ نعرف أنَّ أوائل مَن دعَوْا إلى استعمال العامِّيَّة في الكتابة والتأليف، هم الذين ادَّعَوْا صعوبةَ الفصحى، وادَّعَوْا أنَّ جهلَ المصريين وتخلَّفهم عائدٌ إلى أنَّهم يكتبون بلغة لا يتكلَّمون بها في حياتهم اليومية، بل ادَّعَوْا أنَّ حروف العربيَّة عاجزة لا تصلح لكتابة العربيَّة، فينبغي لنا أنْ نكتبها بحروف لاتينيَّة تُبَيِّنُ لنا النُّطق الصَّحيح! هؤلاء جميعًا كانوا أجانبَ خاصَّةً في أوائل عهد الاحتلال البريطانيِّ لمصر.
ولعلَّ أوَّلَهم الألمانيُّ «وِلْهلم سبيتا» «Wilhelm Spitta» وكان مديرًا لدار الكتب المصريَّة، وهو صاحب أوِّل كتاب في قواعد العربيِّة العامِّيَّة في مصر، ادَّعى فيه صعوبة الفصحى، ودعا لاستعمال الحروف اللاتينيَّة في كتابة العامَّيِّة مُدَّعِيًا أنَّ الحروفَ العربيَّةَ خاليةٌ مِن أصواتِ الحركة «Vowles»، وقد اقتصر على دراسة لهجة القاهرة، واعترف أنَّ اسمَ كتابه كان يجب أنْ يكون «قواعد اللغة العامِّيَّة العربيَّة التي يتحدَّث بها أهل القاهرة»
ثمَّ تلاه الألمانيُّ «كارل فولرس» «K. Vollers»، الذي كان أيضًا مديرًا لدار الكتب المصريَّة، كما أنَّه أحد كُتّاب دائرة المعارف الإسلامية! والإنجليزيُّ «سيلدن وِلْمور» «Seldon Willmore» وكان قاضيًا بالمحاكم الأهليَّة بالقاهرة، والإنجليزيُّ «وِلْيَمْ وِلْكوكْس» «William Willcoks» وكان مهندسًا للريِّ بالقاهرة. [انظر كتاب: تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر ١٨-٣٢]
إذًا آباءُ هذه الدَّعْوة إلى العامِّيَّة هم أبناء الاحتلال والاستعمار، ولا يخفى على دارِس التّاريخِ سَعْيُ كلِّ احتلالٍ لطمسِ هُويَّة ضحاياه، وعلى رأس أدوات طمس الهُويَّة تدميرُ اللُّغة، وإلغاؤها إلغاءً في التَّعليم والوثائق الرَّسميَّة ومناحي الحياة كافَّةً، هذا دَيْدَنُ كُلِّ احتلال على اختلاف أشكاله وأجناسه، وإليه أشار الأديبُ الفرنسيُّ «ألفونس دوديه Alphonse Daudet» في قصَّته «الدَّرس الأخير LaDernière Classe» يحكي لنا عن صدور الأمر مِن بِرْلينَ بتدريسِ الألمانيَّة فَقط وإلغاء تدريس الفرنسيَّة، في منطقة «الألزاس واللّورين» الفرنسيَّة.
هَلِ العَرَبِيَّةُ أَصْعَبُ لُغَةٍ في العالَمِ؟
قال لي أحدُ طلّابي -وهو صَحَفيٌّ يعمل في أمريكا: إنَّه لا يعرفُ لغةً أصعبَ مِن العربيَّة؟ سألتُه: لمَ؟ قال: لقد خُدعنا إذْ تعلَّمْنا أنَّ الحروف الأبجديَّة ٢٨ حرفًا فقط! سألتُه: فكم هي إذًا؟ قال: ضاعف هذا العدد مرَّتَيْنِ أو ثلاثًا، فإنَّ كلَّ حرفٍ يُفتح ويُضم ويُكسر فيختلِف نًطْقه!
إنَّ أبسطَ وَحْدَةٍ تتألَّف منها أيُّ لُغة هي الصَّوْت، فالحرف إنَّما هو صوت، وحَدُّ اللُّغَة عند صاحب الخصائص:
«أصوات يُعبِّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم» [ابن جني – الخصائص ١/ ٣٤]
وإنَّ أصواتَ كلِّ لغةٍ نوعانِ؛ الصوامت Consonants، وهي في العربيَّة حروف الهجاء الثَّمانيةُ والعِشرونَ، بدايةً من الهمزة فالباء فالتّاء وانتهاءً إلى الياء، والصَّوائت أو الحَركات Vowels، وفي العربيَّة حركاتٌ قصيرة؛ الفتحة والضمة والكسرة، وقد تطول فتصير مدًّا بالألف أو بالواو أو بالياء.
ولا يحصل في العربيَّة أن تُنطَق الضمةُ بغير زَمِّ الشَّفَتَيْنِ، فإنَّ لها طريقةً واحدة، الضمَّةُ ضمَّةٌ دائمًا مهما يَكُنِ الصامِتُ الذي تَعْتَليهِ، على خلافِ الإنجليزية، التي فيها ٢٦ حرفًا، مِنْها ٢١ صامِتًا، وأصوات الحركة الإنجليزيَّة خمسة هي a,e,i,o & u، وَلْنضربْ مثلًا بالحَرْفِ u، فَلَنْ تَجد له صوتًا مُسْتَقِرًّا وطريقةَ نطقٍ ثابتة، فَنُطْقُكَ له في كلمة«fuse» يختلف عن كلمة «umbrella» وعن كلمة «full» وعن كلمة «just»، ولاحظ مثلًا اختلاف النُّطق بين الكلمات:
«Plough – through – enough – thought – thorough»
رغم أنَّفها جميعًا تحوي الأحرف «ough»، وليس هذا قَدْحًا في الإنجليزيَّة، لكنَّه بيانٌ لجانب مِن خصائصها الصوتيَّة، الذي لا يخلو من شذوذ غَيْرِ مَقيس، ولا شكَّ أن العربية في أصواتها أيسَر؛ لأنَّها قياسيَّة.
في الألمانيَّة مُذكَّر ومُؤنَّث وجِنْسٌ مُحايِد! وفي الفرنسيَّة تصريفاتٌ كثيرة للفعل الواحد قد تَصِل إلى عَشَرَة! وفي العربيَّة مذكَّر ومُؤنَّث، وماضٍ ومضارعٌ وأمر، فهل العربيَّة أصعب اللغات حقًّا؟ لقد كتبَ الله للعربيَّة مِن الكمال ما لم يكتبه لغيرها، فهِيَ أكمل اللُّغات صوتًا وصرفًا ونحوًا، وهي لغةٌ جُلُّها قِياسِيٌّ، وقد اصطفاها الله وعاءً لشريعته الخاتمة التي تحملُ الحقَّ والخيرَ إلى آخر الزَّمان، فهل اختار ربُّنا أصعَب اللغاتِ ليُكَلِّمَ بها العالمينَ؟!
إنَّ مَن يصف لُغةً بالصُّعوبة إنَّما يصفُها بذلك لِتَعَثُّرِهِ في تعلُّمها، لا لذاتِها وخصائصِها، فاليابانيُّ لن يقول إنَّ لغتَه صعبة! لكنَّ العربيَّ الذي تعلَّم اليابانيَّة لغةً ثانيةً أو ثالثةً قد يَجِدُ فيها عَنَتًا وصعوبة، وربَّما إذا دفعَ المُتعلِّمَ دافعُ إعجابٍ أو مصلحةٍ عِلميَّة أو عمليَّة لتعلِّم اليابانيَّة، صُيِّر ذلك العَنَت مُتعةً، وتلك الصُّعوبةُ يُسْرًا. إنَّ دُوَلَ المشرق العربيِّ اهتمَّتْ بتعليم الإنجليزيَّة لغةً ثانية، بينما اهتمَّتْ دُوَلُ المغرب بالفرنسيَّة، وقد قابلتُ مَغاربةَ كُثْرًا يُتقنونَ الفرنسيَّة إتقانَ الفرَنسيّينَ، ولكنَّهم يجدونَ كُلَّ الصُّعوبة في الإنجليزيَّة، وَلَتَجِدَنَّ المشارقة يرَوْنَ كُلَّ الصُّعوبة في الفرنسيَّة، وما فَرَضَ هذه الألسنةَ على بُلْداننا إلّا الاستعمار، الذي رحل جنودُه، وبَقِيَ عَقْلُه ولِسانه في عقول أبناءِ العربيَّة وعلى ألسِنَتِهم، يَنْطِقونَ بَهجين أشْوَهَ لا عربيٍّ ولا أعجميٍّ، وعلى لافتات محالِّهم، بل وعلى قُمْصانِهم! ما أجدرَ أن يعتزَّ كلُّ إنسانٍ بلِسانه! لا يَمْنَعَهُ ذلك مِنْ تعلُّم ألسنةً أخرى، يوسِّع بها مداركه، ويتعرَّف ثقافاتِ العالَم، ويكتسب علومَه وفنونَه، مِنْ دون أنْ يفقدَ ذاته، ويذوبَ في الآخر ذوبًا.
العامِّيَّةُ أقْوامٌ شَتّى
العامِّيَّة أقوام شتّى، فالعامِّيَّة تختلف في البلد الواحد، وتَتَشَّعَبُ إلى لَهَجات كثيرة، بينما العربيَّة لغة مُوَحَّدَةٌ مُوَحِّدَةٌ، يفهمها ساكن المشرق ويفهمها ساكن المغرب، ومِن عجيبِ ما يقوله الدّاعونَ لاستعمال العامِّيَّة في الكتابة حين يُناظرونَ المُتَمَسِّكينَ بالفُصحى: العربيَّةُ لغةُ القرآن، نعم، لكنَّها لا تصلح للتعبير عن كلِّ المواقف، لذا نلجأ للكتابة بالعامِّيَّة والحديث بها! وهؤلاءِ المُتحدِّثونَ مُسْلِمونَ! يُؤمنونَ أنَّ القرآنَ الكريم هو كلامُ ربِّنا سبحانه وتعالى، إذًا اختار اللهُ عزَّ وجلَّ اللُّغةَ العربيَّةَ لتكونَ اللُّغة التي يخاطب بها العالمينَ منذ نزل القرآنُ إلى قيام القيامة، وبهذه اللُّغة يهتدي الناسُ إلى عبادة ربِّهم الأحد الصمد، وعمارةِ الأرض، أليس عجيبًا أنْ يأتيَ مَن يُسمّي نفسَه مُثَقَّفًا لِيقولَ إنَّ هذه اللُّغةَ التي اختارها الله عزَّ وجلَّ لا تناسبُ مَوْقِفًا يَقِفُه، أو موضوعًا يريد التَّعبير عنه؟! آلعيبُ عيبُ اللُّغة هنا أم عيب مستخدم اللغة؟ وما يمنعك عن تعلُّم لسان العربِ كما تتعلَّم أيَّ لغة؟! ووَيْحَك أيُّها العربيُّ الجاهلُ مِقدارَ لُغتِه وقُدراتِها، أيُّ لُغةٌ أقدَرُ على التعَّبير عما يجيش في الصدور، وينقدح في العقول من لُغتنا العربيَّة؟!
يا صديقي المُثَقَّف إلامَ تدعو؟ ألست تدعو إلى استعمال العامِّيَّة لغةَ أدب وكتابة؟ لِأسأَلْكَ سؤالًا: أيُّهما أرقى: العربيَّة الفُصحى التي اختارها ربُّ العباد لغةَ القرآن والنبيِّ العدنان، أم العامِّيَّة التي نستعملها في الشارع والسوق والحياة اليومية؟ أَشُكُّ أنَّ عاقلًا مُنْصِفًا يذهبُ إلى أنَّ العامِّيَّةَ أرقى مِن الفُصحى في أيِّ لغة! فكيف بالعربيَّة التي شرَّفها الله وقدَّسها باصفطائها لغةَ كلامِه الخالد الباقي، إنَّ مَن يدعو إلى اتخاذ العامِّيَّة لغةَ كتابةٍ وأدبٍ وتركِ الفصحى، لا يدعو إلّا إلى استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، ومَنْ يدعو إلى تعلُّم العربيَّة وإتقانها استماعًا وتحدُّثًا وقراءةً وكتابةً، إنَّما يدعو إلى المجد كلِّ المجد، مَن لم يُتقن لغتَه فهذا تقصير وضعف، أيكونُ علاج هذا الضعف بأنْ ندعوَه ليتعلَّم لغات الآخرينَ هاجرًا لُغته الأم؟ أيكون دَواؤه أنْ نرميَ لغتَه بالعجز عن التعبير؟ أم نُقوّي ضعفَه بتعليمه، وحثِّه على إتقان لغته، وتيسير تعليمها وتعلُّمها؟!
لا أدعو أبدًا ألّا يتعلمَ العربيُّ لغةً ثانيةً وثالثةً ورابعةً وخامسةً، بل أخْلِقْ بنا أنْ نتعلَّم لغاتِ العالم في هذا العصر! لِنَنْفَتِحَ على علومه وثقافاته ونَنْهَلَ منها، بشرط أنْ نُتقنَ لُغتنا، لِتكونَ مِن ثقافات العالَم مصباحًا منيرًا، يهدينا إلى الحقِّ والعَدْل والجمال، ويَكْشف مواضعَ القُبح والشرِّ فنتجنَّبها.
ثمَّ يقول أحدُهم: ماذا قدَّمَ لنا تعلُّمُ العربيَّة؟ ماذا قدَّم لنا الإعرابُ غيرَ وجَعِ الرَّأس؟ الأَوْلى أنْ نتعلَّم علوم الفيزياء والكيمياء والبرمجة والذكاء الاصطناعيِّ التي سبقنا بها العالم، وهذا كلامٌ ساذج أحمق؛ لأنَّه يوجِدُ تعارضًا وهْميًّا بين تعلُّم اللُّغة وتحصيل العلوم، ويضرب المثال بأُمَمٍ بَرَعَت في العِلم والبحث -لا جدالَ- لكنَّها ما توقَّفَتْ عن تعليم لُغاتها لأبنائِها، ولم تُعَلِّمْهُمْ تلك العلوم بِلُغات غيرهم، بل كانوا حريصين كلَّ الحرص على تطوير طرائق تعليم لغاتهم في المدارس والجامعات وبرامج الإعلام، ولا عجِبَ؛ فإنَّه ما تقدَّمَتْ أمَّةٌ قَطُّ بِلُغَةِ غيرها.
وأنَّى لأُمَّةٍ أنْ تنشر عِلْمَها إنْ لم تمتلك لسانًا؟! لقد صدق صاحب أسرار البلاغة إذ يقول عن الكلام والبيان:
«اعلم أنَّ الكلامَ هو الذي يُعطي العلومَ منازلها، ويُبيِّن مراتِبَها، ويكشفُ عن صُوَرِها، ويجني صنوفَ ثَمَرها، ويدلُّ على سرائرها، ويُبْرِزُ مكنون ضمائرها… فلولاه لم تكن لتتعدّى فوائدُ العلمِ عالِمَه، ولا صحَّ مِن العاقلِ أنْ يَفْتُقَ عن أزاهير العقلِ كمائمه، ولتعطَّلَتْ قُوَى الخواطر والأفكار مِنْ معانيها، واستوَتِ القضيَّة في مَوْجودِها وفانيها، نَعمْ، وَلَوَقَعَ الحيُّ الحسَّاس في مرتبةِ الجماد» [عبد القاهر الجرجاني – أسرار البلاغة ٣]
لماذا نَجِدُ الفُصْحى صَعْبَةً؟
لا بأسَ أنْ تسألَ يا أخي: لماذا نجد اللُّغة العربيَّة الفُصحى صعبةً؟ اعلم أنَّ الفصاحة مرادف الوضوح والسُّهولة، في معجم مقاييس اللُّغة:
«(فَصَحَ) الْفَاءُ وَالصَّادُ وَالْحَاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى خُلُوصٍ فِي شَيْءٍ وَنَقَاءٍ مِنَ الشَّوْبِ… فَصُحَ اللَّبَنُ فَهُوَ فَصِيحٌ، إِذَا أُخِذَتْ عَنْهُ الرِّغْوَةُ، وَيَقُولُونَ: أَفْصَحَ الصُّبْحُ، إِذَا بَدَا ضَوْءُهُ» [أحمد بن فارس – مقاييس اللغة ٤ /٥٠٦-٥٠٧]
فالكلام الفصيح هو السهل الواضح، وليس كل عربيٍّ فصيح صَعْبًا، وليس كُلُّ عامِّيٍّ ركيكٍ سهلًا.
العجيب أنْ يقول بعض الناس: إنَّ العربيَّةَ أصعبُ اللُّغات، على سبيل الافتخار! أقول: إنَّ كُلَّ لُغة تُتعلَّم، وقد سبقَ أنْ بيَّنّا ما في العَرَبِيَّة مِنْ يُسرٍ ليسَ في غيْرِها، ولا يَصِحُّ أنْ يُقالَ في مقامِ التعلُّمِ: الإنجليزيَّةُ أسهل الصينيَّة، أو الصينيَّةُ أصعبُ مِن غيرها، مَن وضع معيار هذا التقسيم؟! اللغاتُ تُتَعلَّم بالسماع والتحدُّث، والطفلُ أَقْدَرُ على اكتساب اللُّغة، أَسْمِعْهُ العربيَّة السَّليمة المُمْتعة كلَّ يوم، يكُن مِن الفُصَحاء، قال ابْنُ خلدون:
«والسَّمْعُ أبو المَلَكاتِ اللِّسانِيَّةِ» [تاريخ ابن خلدون ١/ ٧٥٤]
فهل جعلتَ للعربيَّة نصيبًا مِن يومِك ثمَّ وجدتها صعبة؟ وبين أيدينا كلامُ ربِّنا، فهل مِنْ كتابٍ كالقرآن يجري على ألسنة العالَمينَ شرقًا وغربًا يسيرًا سهلًا سائغًا منذُ ما يزيد على ألف وأربعمئة عام؟ لُغته لا يَنْفِرُ منها طبع، ولا تَنْبو عنها أذن، ولا يَضيقُ بها ذَوْق، ويحفظه المسلمُ العربيُّ والأعجميُّ على حدٍّ سواء، وَيَتْلونَه بلسانٍ واحدٍ على اختلافِ أجناسِهم وألوانهم ومشاربهم، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: ١٧]، كَرَّرَها رَبُّنا في سورة القمر أربعًا!
ماذا نَمْلِكُ أنْ نُقدَّمَ لِلْعَرَبِيَّةِ اليَوْمَ؟
يقول قائل: ما عاد أحدٌ يهتمُّ بالعربيَّة، ما عاد أحدٌ يُعنى بإتقان العربيَّة، هل وصلنا إلى الحضيض اللغويِّ؟ لا أنكر أنَّ العربيَّة في بلداننا صارت في ذيل الاهتمامات، وتعليم العربيَّة ونشرُها وحفظُها يحتاج أنْ تُسَنَّ له القوانين الفاعلة، وأنْ تُوَجَّهَ المدارسُ لِتُعَلِّم العربيةَ بالممارسة، استماعًا وتحدّثًا وقراءةً وكتابة.
ما أحوجَنا إلى حصص الاستماع والتحدُّث! ما أحوجَنا إلى أنْ يُسجِّل المُمَثِّلونَ الكبار مُتْقِنو العربيَّة النُّصوصَ أشعارًا وقِصصًا لأطفالنا! ما أحوجَنا إلى برامجَ تلفزيونيَّة تُعَلِّمنا العربيَّة في إطار مُمْتِعٍ يواكب العصر! ما أحوجَنا إلى آباءٍ وأمَّهاتٍ واعينَ يجعلون للعربيَّة نصيبًا يوميًّا في حياة أولادِهم! ما أحوجَنا إلى قُضاةٍ ووُكلاءِ نيابة ومُحامينَ فُصحاء! ما أحوجَنا إلى معلِّمين فصحاء، ما أحوجنا إلى خُطباءَ مُفوَّهين!
إنّي لا أَمْلِكُ سنَّ القوانين وإنفاذها، وتغيير طرائق التَّدْريس، ما أملكه أن أُصَوِّر المرئيّات في قناة عنادل، أنْ أكتُبَ مِثلَ هذا الكتاب، أشدو معكم بجميل العربيَّة، عسى أنْ تَطْرُقَ آذانًا تُغيِّرُ المستقبَل، يَشْحَذُ هِمَّتي تعليقٌ مِنْ مُحِبٍّ في بلد بعيد يستفيد ممّا نقدِّم، ولعلَّه يكونُ مِن الثلاثة التي لا تنقطع مِن ابْنِ آدمَ إذا مات، وأخْلِقْ بأجلِّ الأعمالِ أنْ تُؤَدّى في أحلَكِ الأزمان! إلّا نفعلْ يَبْقَ الظلامُ بهيمًا، ومَنْ يلزمِ البابَ قارعًا، فإنَّه لا شكَّ والجٌ يومًا، قال الشاعر:
إنَّ الأُمورَ إذا انْسَدَّتْ مَسالِكُها *** فَالصَّبْرُ يَفْتَحُ مِنْها كُلَّ مَا ارتُتِجا
لا تَيْأَسَنَّ وإنْ طالَتْ مُطالَبَةٌ *** إذا اسْتَعَنْتَ بِصَبْرٍ أنْ تَرى فَرَجا
أَخْلِقْ بِذي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظى بِحاجَتِهِ! *** وَمُدْمِنِ القَرْعِ للأَبْوابِ أَنْ يَلِجا