لِمَ الحديث عن “لغة المعلِّم”؟
إذا أردنا إصلاحًا حقيقيًّا في تعليم اللغة العربيَّة، فلا مفرَّ من هذا السؤال: بأيِّ لُغةٍ يتحدَّث المعلِّم في الفَصل؟ أهي الفُصحى الجميلة الواضحة؟ أم هي عاميَّة البيتِ والسوق والشارع؟
قلّما تجد معلمَ لغة عربية يَزينُ بالعربيةِ الفصيحة لسانَه في درسِه! قد تجد مِن المعلِّمين من يتقنُ الفصحى كتابةً وقراءة، لكنَّ ألسنَتهم تخونهم إذا وقفوا لِيُدرِّسوا، أو لِيُجيبوا، أو لِيُوجِّهوا، فإذا تحدَّثوا إلى طلابهم بالعربيَّة دقيقةً واحدة امتلأت أفواهُهُم لحنًا وغلطًا، ففرّوا من سماء العربيِّة إلى قاعِ العاميَّة،
لتكون رفيقة كلِّ جملة، وإنْ سلَّموا على زملائهم، اختفت الفصحى حتى مِن التحيات العابرة!
وما ذلك عن جهل بقواعد اللغة وعلومها، وإنَّما حالُهم كذلك لأنَّ اللغة صَنعة، والصَّنعة تصقلها الممارَسة، فإذا غابت الفصحى عن أذنك ولسانِك، فأنّى لها أن تستجيب لك إذا دعوتها إلى لسانك استجابةً هيِّنةً سلسلة يسيرة.
«فإنَّ العلمَ بقوانين الإعرابِ إنَّما هو علمٌ بكيفيَّة العمل، وليس هو نفسَ العملِ، ولذلك نجد كثيرًا مِن جهابذة النَّحاة والمهرة في صناعة العربيَّة المحيطين علمًا بتلك القوانين، إذا سُئِلَ في كتابة سطريْنِ إلى أخيه أو ذي مودَّته، أو شكوى ظُلامة، أو قصد من قصوده، أخطأ فيها عنِ الصَّواب وأكثر مِن اللَّحن ولم يُجِدْ تأليف الكلام لذلك، والعبارة عن المقصود على أساليب اللِّسان العربيِّ» [تاريخ ابن خلدون 1/ 773]
فإذا أردنا غرسَ الفُصحى في نفوس النشء، فإنَّ المعلِّم هو الأرض الخصبة التي تبدأ منها البذر، وهو القدوة اللُّغوية التي يتطلَّع إليها الطلّاب، بل اعلم أنَّه
«مِن المضحِكِ حقًّا أنْ تجِدَ مُدرِّسَ النحو أو الصرف أو البلاغة، أو مفسِّر النصوص العربية من شعرٍ ونثر، يلقي دروسَه وقواعده
بلغة عامِّيَّة، لا يراعي ما يقول من قوانين، ولا يقوِّم لسانه بما يسرُد من قواعد». [محمد عرفة، مشكلة اللغة العربية.. لماذا أخفقنا في تعليمها؟ وكيف نُعلِّمها؟]
المعلِّم مُربٍّ… واللِّسان سلاحُه
المعلِّم ليس موظفًا يُفرِّغ المعلومات في عقول الطلبة إفراغًا، بل هو مُربٍّ، والمربّي يُربِّي بالقدوة قبل اللسان، كأنَّ الكلمة التي يَنطق بها نسمة لطيفة تُحبِّب قبل أن تُوجِّه وتدرِّس، فإذا كانت اللغة التي يستعملها المعلِّم فُصحى، فإنَّها ستسري في أوصال الطالب كما تسري في سمعه، وإذا رأى حرص أستاذه على لغتنا العربيَّة، وأنّه لا يعدل عنها إلى سواها، فإنه سيسعى أن يكون مثلَه، وإذا تحوَّل درسُ النحو عن درس القاعدة الجافة المنعزلة عن المهارات اللغوية الأربع، إلى درس التطبيق والممارسة وإنتاج الكلام تحدُّثًا وكتابة، فإنَّ القاعدة النحوية حينئذٍ ستغدو فطرةً وسجيَّة، ومهارةً تجيب اللسان متى دعاها، وتلبّي القلم متى طلبها.
أرأيتَ كيف يُقلِّد الطفلُ لحن المعلِّم؟ كيف يُردِّد طريقته؟ إنَّ المعلِّم يزرع بأسلوب تَكلُّمه أكثرَ ممَّا يزرع بشرحه المباشر، وإنَّ فُصحاه هي أوَّل البذور.
الفُصحى في التعليم… لماذا نُهمِلها؟!
قد يقول قائل: “لكنَّ المعلِّم يتكلَّم في موضوع علمي، واللغة العامِّيَّة تُسعفه وتُقرِّبه مِن الطالب“.
وأقول: أيُّ قربٍ نرجوه إذا كانت لغتنا هي الثمن؟! وكيف للغةٍ أن تُعلَّم بغيرها؟!
إنَّ اللغة العربيَّة ليست عائقًا في وجه الفهم، بل العائق الحقيقي هو الكسل عن استخدامها، أترى من المنطقي أن تُدرِّس درسًا في اللغة العربيّة وأنتَ تستعمل العاميَّة في شرحه؟! أتُعلِّم الأطفال “الفاعل مرفوع” وأنتَ تنصبه ظلمًا وعُدوانًا تارةً، وتارةً تجرُّه بهتانًا وإثمًا مبينًا!
صدق أبو الأسود الدؤلي إذ يقول:
لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتأتِيَ مثلَهُ *** عارٌ عليكَ إذا فعلتَ عظيمُ
ألا فاعلمْ أنَّ العامِّيَّة في درس العربية لا تُقرِّب، بل تُخرِّب، لأنّها تسلخ الطالب عن الفصحى من حيث لا تدري، لِتَبقَ العامِّيَّة في مواضعها؛ لغة السوق والبيت والشارع، أمَّا درسُ لغتنا العربيَّة فهو لها وحدَها لا تزاحمها العامِّيَّة فيه.
مِن الفم إلى القلب… كيف تؤثِّر فُصحى المعلِّم؟
أثرُ المعلِّم لا يتوقَّف عند المعلومات، بل يصل إلى التكوين الداخليِّ، إلى نبرة الصوت وموسيقى الكلام وإيقاع اللغة، وكلُّها عناصر تُسهم في بناء الذائقة اللغويَّة للطالب.
المعلِّمُ الذي يتحدَّث الفصحى كلَّ يوم، حتى في أسئلة الحضور والانصراف، أو حين يُنادِي على الطالب ليُعيدَ الكُرّاسة، هو معلِّمٌ يصنع بيئة لغويَّة وارفة الظلال، واسعة الأفنان.
لقد كانت ألسنة التلاميذ في جيلٍ مضى أكثرَ اتزانًا، لا لأنّهم حفظوا قواعد النحو عن ظهر قلب، بل لأنَّ معلِّميهم كانوا يتحدَّثون الفُصحى!
أعذار لا تنتهي… وجوابٌ واحد!
كثيرًا ما نسمع الأعذار:
“الفصحى تُربك الأطفال“
“لن يفهم الطالب إذا تحدَّثتُ فصحى“
لكنَّ الحقيقة أنَّ هذه الأعذار هي حجَّة الضعيف الكَسول، وهي أشواكٌ لا تميطها عن الألسنة الحيَّة إلا النيّةُ الصادقة والعزم الصادق.
مَن يَحترمْ لغتَهُ يُتقنْها، ولا يُعلِّمْها بغيرها.
لِسانُ المعلِّم… قدوة أم عثرة؟
إنَّ الطالب الذي يرى أستاذه يكتب الفصحى ويقرأ الفصحى، ثم يتحدّث بالعاميَّة، سيَفهم رسالةً واحدة: الفُصحى ليست للحديث، بل للامتحان فقط.
إذا بَقِيَ هذا الفهم عند الطالب، فلن يحبَّ لغَته العربيَّة، ولن يُتقنَها، علِّمه أيَّها المعلم أنَّ لغتنا العربيَّة لغةُ حياة.
ماذا أفعل إنْ لم أتقن الفصحى بعد؟
لا عَيبَ في البداية المتواضعة، بل العيبُ في الجمود. إنّ المعلِّم الذي يُدرِّب نفسَه على التحدُّث بالفصحى في مواقف الحياة اليوميَّة، ويبدأ بجُمل بسيطةٍ واضحةٍ أمام طلابه، سيتقدَّم كلَّ يوم خُطوة، والمفتاح هو الصدق والإصرار، وإنَّ مَن صدقَ مع لغته، صدقَ معه طلابه.
مِن المعلِّم تبدأ النَّهضة
كلُّ مُعلِّم يتحدَّث الفصحى يُسهم في إصلاحٍ عظيم، لا تُقاس آثاره بالدرجات والامتحانات، بل تُقاس بما يَرسُخ في قلب الطالب مِن حبٍّ للغة، وتعلُّقٍ بها، واستعدادٍ للتحدُّث بها.
ومن المعلِّم تبدأ النهضة، لا تَقلِّل من أثر كلمتك، ولا تَستصغر لغتك، الفصحى التي تنطق بها اليوم، هي التي ستُزهِر غدًا في فم طالب، أو في قلم كاتب، أو في صوت مُعلِّق، أو في لسان خطيب.
في المقالة القادمة…
في المقالة القادمة، سنتحدَّث عن المدرسة: هل بيئتها تُساعِد على التحدُّث بالفُصحى؟ وكيف نُحوّل الصفَّ إلى ساحةٍ حيّةٍ للفصاحة والبيان؟
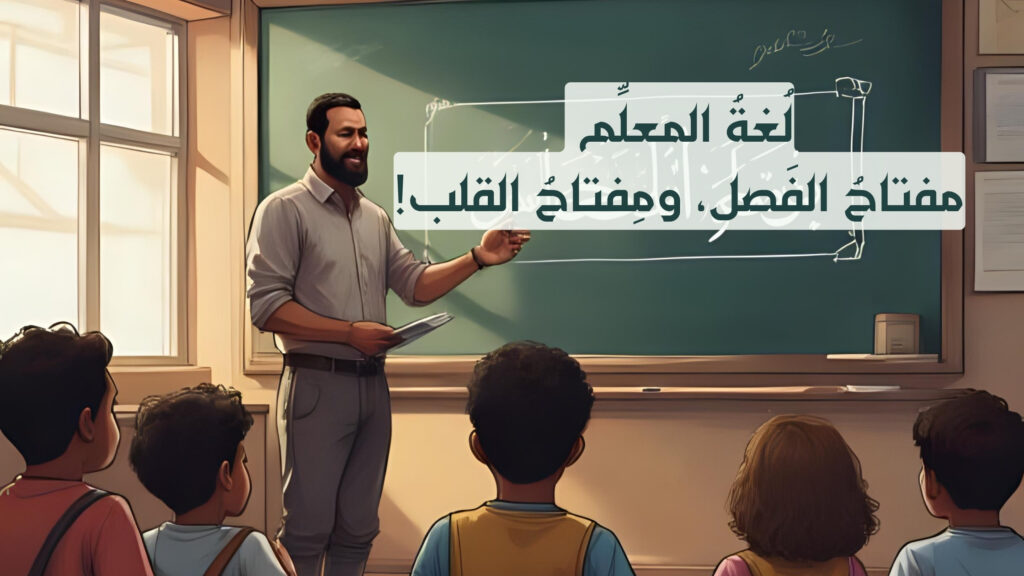
عنادل ، الشكر لك قد استفدت كثيرا.
العربية مفتاح العلوم .